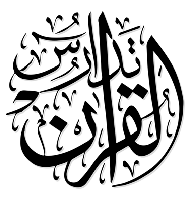قوله تعالي : " قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) " { يوسف : 47 – 49 } .
قال ابن الجواليقي : " ولا تُفرّقُ عوامُّ النّاس بين ( العام ) و ( السَّنَةِ ) ، ويجعلونهما بمعنًي واحدٍ ، فيقولون : سافرَ في وقتٍ من السَّنَةِ ، أي : وقتَ كان إلي مثله ذلك ، وهو غلطٌ ، والصوابُ ما أُخبِرتُ به عن أحمد بن يحي أنّه قال : ( السَّنَةُ ) من أيّ يومٍ عددتَهُ إلي مثله . و( العامُ ) لا يكون إلا شتاءً وصيفًا ، وليس ( السَّنَةُ ) و( العامُ ) مشتقّين من شئ ، فإذا عددتَ من اليوم إلي مثله فهو سَّنَةٌ ، يدخلُ فيه نصفُ الشتاء ونصفُ الصيف ، والعامُ لا يكون إلا صيفًا وشتاءً ... فالعامُ أخصُّ من السَّنَةِ ، فعلي هذا تقول : كلُّ ( عامٍ ) سَّنَةٌ ، وليس كلُّ ( سَنَةٍ ) عامًا " انتهى من تاج العروس للزبيدى : 8 / 413 .
وقال الراغب الأصفهانيّ في كتابه ( المفردات ) ص 245 : " وأكثر ما تُستعملُ السَّنَةُ في الحَوْلِ الذي فيه الجَدْبُ ، يقال : أسنتَ القومُ ، أصابتهم السَّنَةُ " ، وقال في موضعٍ آخر ص 354 : " العامُ كالسَّنَةِ لكن كثيرًا ما تُسْتَعْملُ السَّنَةُ في الحَوْلِ الذي يكون فيه الشدّةُ أو الجَدَبُ ، ولهذا يُعبّرُ عن الجَدْبِ بالسَّنَةِ ، والعام بما فيه الرخاء والخِصْبُ " .
وقد سار أكثر المفسّرين – أبى السعود : 4 / 238 - علي التفريق بينهما من حيث القَحْطُ والخِصْبُ ، واستشهدوا علي ذلك بأحاديث ، منها ما رواه مسلمٌ - رحمه الله - عن ثوبان - رضي الله عنه - أنّ رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ( .... وإنّي سألتُ ربّي لأمّتي أن لا يهلكها بسنةٍ بعامّهٍ ) صحيح مسلم : 3 / 2215 .
وأقول : أوضح منه في الاستشهاد ما رواه مسلمٌ - رحمه الله - عن أبي هريرة أنّ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال : ( ليست السَّنَةُ بأن لا تُمطروا ، ولكنّ السَّنَةَ أن تُمطروا ، وتمطروا ، ولا تُنبِتُ الأرضُ شيئًا ) صحيح مسلم : 3 / 2228 . ؛ لأنّ رسول الله - صلي الله صلي الله عليه وسلم - سار في تعريفه للسَّنَةِ علي ما يعرفه أصحابه - رضي الله عنهم - ، ثمّ بيّنَ لهم التعريف الصحيحَ لهم .
ولكنْ فرّقَ بينهما أبو هلال العسكريّ من جوانب أخري ، فقال الفروق اللغوية : 224 : " الفرق بين ( العام ) و( السَّنَةِ ) أنّ العامَ جمعُ أيّامٍ ، والسَّنَةَ جمعُ شهورٍ ، ألا تري أنّه لمّا كان يُقال : أيّامُ الرنْجِ ، قيل عامُ الرنْجِ ، ولمّا لم يُقَل : شهورُ الرنْجِ ، لم يُقَلْ : سنة الرنْجِ .
ويجوز أن يقال : ( العام ) يفيد كونه وقتًا لشئ ، ( والسَّنَةُ ) لا تفيد ذلك , ولهذا يقال : عامُ الفيل ، ولا يقال : سنة الفيل ، ويقال في التاريخ : سنة مئةٍ ، وسنة خمسين ، ولا يقال : عام مئة وعام خمسين ؛ إذ ليس وقتًا لشئ ممّا ذُكِرَ من هذا العددِ ، ومع هذا فإنّ العامَ هو السَّنَةُ ، والسَّنَةَ هي العامُ ، وإن اقتضي كلُّ واحد منهما ما لا يقتضيه الآخر ممّا ذكرناه ، كما أن الكلَّ هو الجَمْعُ ، والجَمْعُ هو الكلُّ ، وإن كان الكلُّ إحاطةً بالأبعاض ، والجَمْعُ إحاطةً بالأجزاء " .
ويري السهيليّ - رحمه الله - أنّ الفرق بينهما أنّ ( العام ) يطلق علي ذي الشهور القمريّة ، وأمّا ( السنة ) فتطلق علي ذات الشهور الشمسيّة الروض الأنف 2 / 57 – 59 .
وعودًا إلي الآيات التي هي محلّ هذه النظرة نجد المولي - عز وجل - قال : " سَبْعَ سِنِينَ " , ثمّ قال : " عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ " , ففي الأولي استعمل السنين , ثمّ استعمل العام , فما السرّ في ذلك ؟ .
قال السهيلي - رحمه الله – الروض الأنف : 2 / 57 – 58 : " قال : " سِنِينَ " , ولم يقل : ( أعواما ) , و السَّنَةُ و العامُ - وإن اتّسعت العربُ فيهما واستعملتْ كلَّ واحد منهما مكانَ الآخر اتّساعًا - ولكَنَّ بينهما في حكم البلاغة والعلم بتنـزيل الكلام فرقًا فَخُذْهُ :
أولًا : من الاشتقاق ؛ فإنّ السَّنَهَ من : سَنا , يَسْنُو , إذا دار حول البئر والدابّة : هي السانية , فكذلك السَّنَهُ : دورةٌ من دورات الشمس , وقد تسمّي السَّنَةُ ( دارا ) ؛ ففي الخبر : ( إنّ بين آدم ونوحٍ ألفَ دارا ) , أي : ألف سَّنَةٍ هذا أصل الاسم , ومن ثمّ قالوا : أكلتْهم السَّنَةُ , فسمّوا شدّة القحط سنةً , قال الله سبحانه : " وَلَقَدْ أَخَذْنَا آَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ " الأعراف : 130 , ومن ثمّ قيل : أسنتَ القومُ , إذا أقحطوا .. ؛ لأنّ الجُدُوبَةَ والخِصْبَ معتبرٌ بالشتاء والصيف , وحسابُ العجم إنّما هو بالسنين الشمسيّة , بها يؤرّخون ......
وانظرْ بعد هذا إلي قوله : " تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا " , ولم يقل : ( أعوامًا ) , ففيه شاهدٌ لما تقدّم , غير أنّه قال : " ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ " , ولم يقل : سنة , عدولًا عن اللفظ المشترك ؛ فإن السنة قد يعبّر بها عن الشدّة و الأزمة , كما تقدّم , فلو قال : ( سَّنَةٌ ) لذهب الوهم إليها ؛ لأنَّ العامَ أقلُّ أيّامًا من السنة , وإنّما دلّتِ الرؤيا علي سبعِ سنينَ شدادٍ , و إذا انقضي العدد فليس بعد الشدّة إلا رخاءٌ , وليس في الرؤيا ما يدلُّ علي مدّة ذلك الرخاء , و لا يمكن أن يكون أقلّ من عامٍ , و الزيادة علي العام مشكوكٌ فيها , ولا تقتضيها الرؤيا , فَحُكِمَ بالأقلِّ , وَتُرِكَ ما يقع فيه الشكُّ من الزيادة علي العام , فهاتان فائدتان في اللفظ بالعام في هذا الموطن " .
ثمّ وجَّهَ السهيليّ - رحمه الله - بعض الآيات , فقال الروض الأنف : 2 / 58 – 59 : " وأمّا قوله : " وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً " الأحقاف : 15 , فإنّما ذكر السنين , وهي أطول من الأعوام ؛ لأنّه مخبرٌ عن اكتهالِ الإنسانِ , و تمامِ قوّتِهِ , و استوائِهِ , فلفظ السنين أولى بهذا الموطن ؛ لأنّها أكملُ من الأعوام .
وفائدة أخري : أنه خبرٌ عن السنّ , والسنُّ معتبرٌ بالسنين ؛ لأنّ أصل السنّ في الحيوان لا يُعْتَبَرُ إلا بالسَّنَةِ الشمسيّة ؛ لأنَّ النتاجَ و الحملَ يكون بالربيع والصيف , حتّي قيل : ( رِبعيّ ) للبكيرِ , و ( صيفيّ ) للمُؤخَّرِ ...... , فلمّا قيل ذلك في الفصيل ونحوه : ابنُ سنةٍ , وابن سنتين , قيل ذلك في الآدميّين , وإن كان أصله في الماشية .
وأمّا قوله : " وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ " لقمان : 14 , فلأنّه قال سبحانه : " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ " البقرة : 189 , فالرضاع من الأحكام الشرعية , و قد قصرنا فيها علي الحساب بالأهلّة .
وكذلك قوله : " يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا " التوبة : 37 , ولم يقل : سنة ؛ لأنه يعني شهر المحرّم وربيع إلي آخر العام , ولم يكونوا يحسبون بأيلول , ولا بتشرين ولا بينير , وهي الشهور الشمسية .
وقوله سبحانه : " فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ " البقرة : 259 , إخبارٌ منه لمحمّد - صلي الله عليه وسلم - وأمّته , وحسابهم بالأعوام والأهلّة كما وقّتَ لهم سبحانه .
وقوله سبحانه في قصّة نوح : " فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا " العنكبوت : 14 , قيل : إنّما ذكر أولًا السنين ؛ لأنّه كان في شدائدَ مُدَّتَهُ كُلَّها إلا خمسين عامًا منذ جاءه الفرج , وأتاه الغوث , و يجوز أن يكون الله سبحانه عَلِمَ أنّ عُمُرَهُ كان ألفًا إلا أن الخمسين منها كانتْ أعوامًا فيكون عمره ألفَ سنة , ينقص منها ما بين السنين الشمسية و القمريّة في الخمسين خاصّة ؛ لأن خمسين عامًا بحساب الأهلّة أقلّ من خمسين سنة شمسيّة بنحو عامٍ و نصف , فإن كان الله سبحانه قد عَلِمَ هذا من عُمُره , فاللفظُ موافقٌ لهذا المعني , و إلا ففي القول الأوّل مقنعٌ , والله اعلم بما أراد .
فتأمّل هذا ؛ فإنّ العلم بتنـزيل الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح لك بابًا من العلم بإعجاز القرآن .
وابْنِ هذا الأصلَ تَعْرِفِ المعني في قوله تعالي : " فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) " المعارج : 4 وقوله تعالي : " وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) " الحج : 47 , وأنه كلامٌ وَرَدَ في مَعْرضِ التكثير والتفخيمِ لطول ذلك اليومِ , و السَّنَهُ أطولُ من العامِ , كما تقدّم , فلفظها أليقُ بهذا المقام . ــــ ˮصالح العايد“ ☍... |