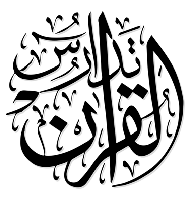آية (٢٣٤) : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)
* أضاف ربنا تعالى (الأجل) إلى النساء المعتدّات فقال (أَجَلَهُنَّ) ولم يقل إذا بلغن الأجل إيحاء إلى أن مشقة هذا الأجل واقعة على المعتدّات فهن الصابرات والمتعبدات بترك الزينة والتزام بيت الزوجية وفي هذا مشقة ولذلك أضاف الأجل إليهن لإزالة ما عسى أن يكون قد بقي في نفوس الناس من إستفظاع تسرّع النساء إلى التزوج بعد عدّة الوفاة خاصةً أهل الزوج المتوفى فنفى الله تعالى هذا الحرج.
* الفعل يتوفون من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول فنقول تُوفيّ فلان ولا نقول توفّى فلان. وقد حدث ذات يوم أن علياً رضي الله عنه كان يشيع جنازة فقال له قائل: من المتوفّي؟ بلفظ إسم الفاعل سائلاً عن الميت فأجاب عليٌّ بقوله (الله) ولم يجبه لينبهه على خطئه.
* ما الفرق بين ختام الآيتين (٢٣٤) و (٢٤٠) مع أنهما تتحدثان عن المتوفى عنها زوجها؟
السياق مختلف في الآية الأولى الوصية للمرأة المتوفى عنها زوجها هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، والآية الثانية الوصية لأهل المتوفى بأن لا تجبر المرأة على الخروج من مسكنها قسراً وإنما تخرج بنفسها (لا تخرجوهن) ولها أن تبقى إلى الحول.
المسألة في الآية الأولى متعلقة بالمرأة والثانية متعلقة بمن يُخرج المرأة. فلما كان الحكم متعلقاً بالمرأة بحمل المرأة واستبراء الرحم يحتاج إلى خبرة فقال خبير والآية الثانية عزيز حكيم كأنه تهديد لمن يخرج المرأة ينتقم ممن خالف الوصية كلمة (وصية) في الآية مفعول مطلق بمعنى يوصي وصية. ربنا عزيز ينتقم بمن خالف هذا الأمر.وفي ذلك حكمة وليس فقط عزيز وإنما حكيم فيها حكمة وفيها حكم إياكم أن تحكموها لأنه الله هو حكيم. حكيم تشمل الحُكم والحِكمة وهي بمثابة ردع وتحذير لمن يحاول أن يُخرج المرأة إذا كنت تحكم هذه المرأة فالله عزيز حكيم. الآية الثانية تهديد لمن يخرج المرأة أما ما يتعلق.
*ما الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و (من معروف)؟
المعرفة في اللغة هي ما دلّ على شيء معين والنكرة ما دلّ على شيء غير معيّن. وفي الآية الأولى المعروف يقصد به الزواج بالذات لأن الآية بعدها (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء ..) أما الآية الثانية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)) فهي عامة ويقصد بـ (مَّعْرُوفٍ) هنا كل ما يُباح لها. ولمّا جاء بالزواج جاء بالباء وهي الدالّة على المصاحبة والإلصاق وهذا هو مفهوم الزواج بمعناه المصاحبة والإلصاق.
* دلالة تقديم العمل على الخبرة الإلهية في ختام الآية (وَاللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) :
هنالك قاعدة استنبطت مما ورد في القرآن الكريم: إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله (وَاللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) ولو كان السياق في غير العمل أو كان في الأمور القلبية أو كان الكلام على الله سبحانه وتعالى قدّم صفة الخبرة (خبير بما تعملون). مثل الآية ٢٣٤ (.. فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) هذا عمل فقدّم العمل، وكذلك (إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٧١)) هذا عمل، أما (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨) النمل) هذا ليس عمل الإنسان فقدّم الخبرة. ــــ ˮمختصر لمسات بيانية“ ☍... |
*(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (234) البقرة) ما دلالة إضافة الأجل إلى النساء؟
انظر أخي المؤمن كيف أضاف ربنا تعالى (الأجل) إلى النساء المعتدّات فقال (فإذا بلغن أجلهن) ولم يقل إذا بلغن الأجل إيحاء إلى أن مشقة هذا الأجل واقعة على المعتدّات فهن الصابرات والمتعبدات بترك الزينة والتزام بيت الزوجية وفي هذا مشقة ولذلك أضاف الأجل إليهن لإزالة ما عسى أن يكون قج بقي في نفوس الناس من إستفظاع تسرّع النساء إلى التزوج بعد عدّة الوفاة لأن أهل الزوج المتوفى قد يتحرجون من ذاك فنفى الله تعالى هذا الحرج.
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ (234) البقرة) إن الفعل يتوفون من الأفعال التي التزمت العرب فيها البناء للمجهول فنقول تُوفيّ فلان ولا نقول توفّى فلان. وقد حدث ذات يوم أن علياً رضي الله عنه كان يشيع جنازة فقال له قائل: من المتوفّي؟ بلفظ إسم الفاعل سائلاً عن المتوفى فأجاب عليٌّ بقوله (الله) ولم يجبه كما يقصد بأنه مات فلان لينبهه على خطئه. ــــ ˮبرنامج ورتل القران ترتيلا“ ☍... |
*افتتحت الآيتان (234)و(240) فى سورة البقرة بنفس العبارة (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ) فما الفرق بين ختام الآيتين مع أنهماتتحدثان عن المتوفى عنها زوجها؟
منطوق الآيتين يوضح: الآية الأولى التي أشار إليها (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) يعني خبير بما شرع ويعلم وجه الحكمة في اختيار التوقيت، يتبين الحمل بعد أربعة أشهر كما في الحديث " يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح" ربنا يعلم سبب اختيار التوقيت لماذا اختار الخبير هذا التوقيت؟ أربعة أشهر وعشراً، هذا يحتاج إلى خبرة ومعرفة حتى يعطي الحكم لماذا أربعة أشهر وعشراً؟ هذا خبرة. ثم تترك المرأة هكذا أو تخرج من بيتها؟ هذا يحتاج إلى خبرة في المجتمع يعني هل يصح للمرأة أن تبقى هكذا؟ عند ذلك إذا أرادت أن تخرج بعد ذلك فلا بأس لأن بقاءها قد يكون فيه فتنة أو فيه أمر نفسي أو فيه شيء.
الآية الثانية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240) ربنا وصّى الأزواج أنهم لا يخرجوهن من بيوتهم، وصية لمن يتولى الأمر لأن الأزواج ماتوا، تبقى في البيت المرأة وقد يقولون لها أُخرجي من البيت، زوجك خرج فينبغي أن تخرجي فالقرآن يقول لا إياكم أن لا تراعوا الوصية، هن يخرجن من أنفسهن لكن أنتم لا تُخرجوهن. أهل المتوفى يمكن أنهم يريدون أن ينتفعوا من البيت. في الآية الأولى الوصية للمرأة تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه عدة المتوفى عنها زوجها والآية الثانية الوصية لأهل المتوفى بأن لا تُخرج المرأة من مسكنها وإنما تخرج بنفسها (لا تخرجوهن) أي لا تجبر على الخروج ولا تُخرج من البيت قسراً ولها أن تبقى إلى الحول. كلمة (وصية) في الآية مفعول مطلق بمعنى يوصي وصية. ربنا عزيز ينتقم بمن خالف هذا الأمر.
المسألة في الآية الأولى متعلقة بالمرأة والثانية متعلقة بمن يُخرج المرأة. فلما كان الحكم متعلقاً بالمرأة يحتاج إلى خبرة قال خبير والآية الثانية عزيز حكيم كأنه تهديد لمن يخرج المرأة ينتقم ممن خالف الوصية وفي ذلك حكمة وليس فقط عزيز وإنما حكيم فيها حكمة وفيها حكم إياكم أن تحكموها لأنه الله هو حكيم. حكيم تشمل الحُكم والحِكمة وهي بمثابة ردع وتحذير لمن يحاول أن يُخرج المرأة إذا كنت تحكم هذه المرأة فالله عزيز حكيم. وإن تشابهت الآيتين فإن السياق مختلف، الآية الثانية تهديد لمن يخرج المرأة أما ما يتعلق بحمل المرأة واستبراء الرحم يحتاج إلى خبرة. ــــ ˮفاضل السامرائي“ ☍... |
*ما الفرق بين قوله تعالى في سورة البقرة (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) و (من معروف)؟
أولاً يجب أن نلاحظ دلالة التعريف والتنكير فالمعرفة في اللغة هي ما دلّ على شيء معين والنكرة ما دلّ على شيء غير معيّن. وفي الآية الأولى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {234}) المعروف يقصد به الزواج بالذات لأن الآية بعدها (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ {235}). أما الآية الثانية (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {240}) فهي عامة ويقصد بـ (معروف) هنا كل ما يُباح لها. ولمّا جاء بالزواج جاء بالباء وهي الدالّة على المصاحبة والإلصاق وهذا هو مفهوم الزواج بمعناه المصاحبة والإلصاق. ــــ ˮفاضل السامرائي“ ☍... |
*ختمت الآية (وَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فما دلالة تقديم العمل على الخبرة الإلهية؟
هنالك قاعدة استنبطت مما ورد في القرآن الكريم: إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله (والله بما تعملون خبير) لو كان السياق في غير العمل أو كان في الأمور القلبية أو كان الكلام على الله سبحانه وتعالى قدّم صفة الله خبير (خبير بما تعملون). مثال: (إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (271) البقرة) هذا عمل، لما ذكر عمل الإنسان قدّم عمله (بما تعملون خبير)، (وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10) الحديد) هذا عمل، قتال وإنفاق ختمها (والله بما تعملون خبير) لما ذكر عمل الإنسان قدّم عمله. (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) البقرة) هذا عمل فقدّم (والله بما تعملون خبير). (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) التغابن) هذا عمل أيضاً. (وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) النمل) هذا ليس عمل الإنسان فقدّم الخبرة على العمل وقال خبير بما تفعلون. أو لما يكون الأمر قلبياً غير ظاهر (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18) الحشر) فهذا على العموم أنه إذا كان الأمر في عمل الإنسان قدم العمل وإذا كان في غير عمل الإنسان أو في الأمور القلبية أو عن الكلام عن الله سبحانه وتعالى يقدم خبير. العرب كان تعي هذه المعاني والقواعد من حيث البلاغة، البليغ هو الذي يراعي، هذه أمور بلاغية فوق قصد الإفهام يتفنن في صوغ العبارة ومراعاة البلاغة. على سبيل المثال عندما تضيف إلى ياء المتكلم (هذا كتابي، أستاذي، قلمي) بدون نون، بالنسبة للفعل تقول أعطاني، أضاف نون الوقاية، عموم الكلمات نأتي بنون الوقاية مع الفعل مثل ضربني وظلمني أما مع الإسم فلا تأتي هذه قاعدة وعموم الناس يتكلمون بها دون أن يفطنوا إلى أن هذا إسم وهذا فعل، الناس يقولونها وهي قواعد أخذوها على السليقة. الناس يتفاوتون في البلاغة العرب كلهم كانوا يتكلمون كلاماً فصيحاً من حيث صحة الكلام ولذلك يؤخذ من كلام المجانين عندهم لأن المجانين يتكلمون بلغة قومهم ويستشهدون بأشعار المجانين لأن كلامهم يجري على نسق اللغة أما البلاغة فمتفاوتة ويقول : أنا أفصح من نطق بالضاد. صحة الكلام كل واحد يتكلم على لغة قومه أما من ناحية البلاغة فهناك تفاوت. الله تعالى تحداهم في البلاغة وفي طريقة النظم والتعبير وتحداهم بأن يأتوا بسورة والسورة تشمل قصار السور مثل العصر والكوثر سورة، الإخلاص سورة قبل التشريع وهناك إعجاز كثير في القرآن في الإخبار عن المغيبات والمستقبل وعندما تحداهم الله تعالى تحداهم بسورة ليس فيها تشريع وليس فيها إخبار عن الغائب أو عن الماضي. هذا في العلم والبصر وليس في العِلم والخبرة والعمل فقط وهذا خط عام في القرآن. ــــ ˮفاضل السامرائي“ ☍... |
| آيتان تقول هذا (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿234﴾ البقرة) معرّف بالمعروف على وصية الأرامل إذا انتهت الأربعة أشهر وعشرة أيام وراء هذه لا بأس تستطيع أن تفعل ما تريد بنفسها من أن تتزين للخُطّاب تنظف نفسها، على شرط أن يكون هذا بالمعروف المتفق عليه لا أن تخرج سافرة أو تظهر شعرها فقط بما هو جائزٌ في مجتمع الإسلام لا يسبب عاراً ولا يسبب عيباً هذا بالمعروف. نفس هؤلاء الأرامل طبعاً هذا الحكم واجب كل امرأة يموت زوجها عليها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام كعدة لا تتزوج لا تخرج من البيت إلا لحاجة ولكن طبعاً كما شرحنا هذا في برنامج خير الكلام على خلاف ما في العالم العربي إذ يعتبرون الأرملة كأنها معتقلة لا تخرج من الغرفة لا ترى شمساً ولا تلفزيوناً ولا مرآة هذا كله كلام فارغ ما تخرج من البيت. إذاً بالمعروف هذا فيما يتعلق بالأرملة التي مات زوجها وباقي في هذه العدة أربعة أشهر وعشرة أيام (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) هذه الأرملة وهذا فرض واجب من السُنّة أن تبقى في بيت الرجل سنة ويجب أيضاً سُنّة أن يكون الرجل أو أهل الرجل أو هو أوصى أن تنفقوا عليها تعطوها تكرمونها سنة كاملة إلى أن تخرج من البيت. لكن في الآية الأخرى قال فإن (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿240﴾ البقرة) في الآية الأولى (فَإِذَا بَلَغْنَ) وفي الثانية (إِنْ خَرَجْنَ) (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) نفس السياق في الأولى (فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وفي الثانية (فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) هي نفس الحكم ونفس الأرملة ونفس الموضوع ونفس السورة الآية الأولى 234 والثانية 240 فرق بست آيات لماذا هناك (بِالْمَعْرُوفِ) وهنا (مِنْ مَعْرُوفٍ)؟ يعني ما في شيء عبث أو شيء غير مقصود هذا كلام رب العالمين. الألف واللام هناك سورة هذا خاص بالأرملة بالعدة الواجبة عليها فرضاً وهي أربعة أشهر وعشرة أيام تبقى في البيت لا تخرج نهائياً إلا بحاجة ولا تتزين الخ إلى أن تنتهي العدة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) لما تخلص تتطهر تتحسن تتمكيج حتى تتزوج. هنا ليس عدة هنا إبقاء وإكرام إذا رجل قال يا جماعة أنا سأموت زوجتي خلوها عندكم في البيت لا تخرجوها من البيت وأنا أوصي لها بمبلغ مائة ألف درهم تبقى سنة كاملة عندكم فالله قال (فَإِنْ خَرَجْنَ) ما قال فإذا (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) الفرق واضح هناك البقاء واجب وانتهاء العدة بالمائة مائة سيحصل بعد أربعة أشهر وعشرة أيام بالمائة مائة، في هذه الأربعة شهور هي بالضبط مقيمة على حدود قوية ومتفق عليها، كل تصرفات المرأة في العدة هذه كلها متفق عليها هذه (فإذا) وحينئذٍ المعروف المعروف لكل الناس كل الناس تعرف ما هي واجبات المرأة الأرملة بالمعروف الذي تعرفونه أنتم هذه الألف واللام .هناك لا انتهت العدة وستبقى في البيت لأن الزوج وصى أن تبقى في بيت تخرج أو لا تخرج هي حرة، تتزين أو لا تتزين هي حرة، يعني قضية كلها اختيارية وقضية عائلية تبقى أو لا تبقى، تعطوها أو لا تعطوها ليست قضية كبيرة. فحينئذٍ الفرق بين (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الذي هو متفق عليه وهو ضروري وأكيد وسيحصل بالدقيقة والساعة واليوم تنتهي اليوم الأخير اليوم العاشر من الشهر الخامس فهذا بالمعروف قضية متفق عليها الألف واللام هذا ذهني نعرف هذا جميعاً بدليل الآن ما في تقريباً واحد بالمليون يتركون الأرملة في بيت المرحوم زوجها على مدى سنة لا يوجد ولأنه ليس أكيداً ولا واجباً بل من باب الإيصاء بإكرامها قد يكون هذه الأرملة ما عندها أحد أو أولادها صغار يريدهم أن يعيشون مع أهله يعني أنتم أهل الزوج عطوفون على أولاد المرحوم يعني قضية نوع من أنواع الندب رب العالمين سبحانه وتعالى يهيب بنا أن نكرم الأرملة وأولاد المرحوم في بيته، يبقى في بيته يتعلم على الأهل يتعلم على عشيرته على قومه فهي اختيارية كونها اختيارية حتى عمل معروف ما الذي تفعله المرأة بنفسها؟ لا نعرف بالضبط؟ فإذا أحبت أن تخرج فهو من معروف لا تخرج من معروف تتزين من معروف لا تتزين من معروف يمكن تزعل مرات الخ يعني كل تصرفاتها غير منضبطة وغير معروفة سلفاً وغير متفق عليها وإنما تخضع للإرادة والظروف الطارئة فهي من معروف (مِنْ مَعْرُوفٍ) ليست أكيدة ولا منضبطة ولا محددة وكلكم تعلمون بأن الأحكام تناط بما ينضبط لا بما لا ينضبط. فتحركات الأرملة أربعة أشهر منضبطة هذا (بِالْمَعْرُوفِ) أما تحركاتها بعد الأربعة أشهر لمدة سنة ليست منضبطة هي حرة تروح وتأتي هذا (مِنْ مَعْرُوفٍ) فهذه الألف واللام تعطيك أن هذه الأحكام التي على المرأة المعتدة من وفاة أحكام شرعية واجبة عليها أن تنضبط بها هي تعرف هذا وأولاده يعرفون وأهل الزوج يعرفون لكن هناك لا قضية عامة ضيافة فقال (مِنْ مَعْرُوفٍ) ما فيه شيء محدد. ــــ ˮأحمد الكبيسي“ ☍... |
مسات بيانية
الفرق بين ( بما تعملون بصير خبير و بصير خبير بما تعملون )
سورة البقرة
اية 233 ــــ ˮدريد ابراهيم الموصلي“ ☍... |
لماذا قال الله سبحانه : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ } [ البقرة : 240 ] .
وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 233 ] .
فاستعمل الحول , ولم يستعمل العام أو السنة , كما قال الله سبحانه : { وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } [ لقمان : 14 ] .
الجواب : أما السنة والعام والحجة فقد ذكرناها في كتابنا ( من أسرار البيان القرآني – باب المفردات ) .
واما استعمال الحول ههنا , فله مناسبته , ذلك أن معني ( الحول ) السنة " اعتبارا بانقلابها , ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها " .
ومن معاني ( الحول ) في اللغة التحول والتغير , يقال : ( حال ) أي " تحول من موضع إلي موضع , وحال فلان عن العهد ؛ أي : زال " .
ومن معاني ( الحول ) الحجز والمنع , يقال : " حال الشئ بين الشيئين يحول حولا وتحويلا ؛ أي : حجز " .
قال تعالي : { وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ } [ هود : 43 ] .
وقال : { وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ } [ الانفال : 24 ] .
ولم يستعمل القرآن ( الحول ) إلا في حالتي الوفاة أو الطلاق , وكلاهما تحول وحاجز .
قال تعالي : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ....} [ البقرة : 240 ] .
وقال : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [ البقرة : 233 ] .
فقد ذكر بعضهم أن هذه الآية خاصة بالمطلقات , يدل علي ذلك أمران :
الأمر الأول : أن الآية ذكرت عقيب آيات الطلاق , فكانت من تتمتها .
والأمر الآخر : أن إيجاب الرزق والكسوة فيما بعد للمرضعات يقتضي التخصيص ؛ إذ لو كانت الزوجة باقية لوجب علي الزوج ذلك بسبب الزوجية , لا الإرضاع .
والوفاة تحول وتغير , والوفاة حاجز بين الزوجين , فناسب استعمال الحول , والطلاق تحول وتغير وهو حاجز بين الزوجين , فناسب استعمال الحول أيضا .
وذلك من لطيف التناسب ودقته .
(أسئلة بيانية في القرآن الكريم
الجزء الثاني
ص : 21) ــــ ˮفاضل السامرائي“ ☍... |
قوله تعالى: (فَلَا جُنَاحَ عَليْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ. .) .
قال في هذه الآية " بالمعروف " وقال في الآية الأخرى " من معروفٍ " لأن التقدير في هذه: فيما فعلن في أنفسهن بأمر الله المعروف من الشرع.
وفي تلك: فيما فعلن فى أنفسهن من فعلٍ من أفعالهنَّ معروف جوازه شرعاً. ــــ ˮكتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن“ ☍... |
• ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ مع ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ﴾
• ما الفائدة التي أوجبت اختصاص الموضع الأول بالتعريف والباء فقال : ﴿ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ والموضع الثاني بالتنكير ولفظة (من) ؟
• قال الإسكافي : " إن الأول تعلق بقوله : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي : لا جناح عليكم في أن يفعلن في أنفسهم بأمر الله المشهور، وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد انقضاء العدة، فالمعروف هاهنا: أمر الله المشهور، وهو فعله وشرعه الذي شرعه، وبعث عليه عباده.
والموضع الثاني : أن المراد به: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من جملة الأفعال التي لهم أن يفعلن من تزوج أو قعود، فالمعروف هاهنا: فعل من أفعالهم، يعرف في الدين جوازه، وهو بعض ما لهن أن يفعلنه، ولهذا المعنى خص بلفظة من وجاء نكرة ". ــــ ˮكتاب : ﴿ الارتياق فـي توجيـه المتشابـه اللفظـي ﴾“ ☍... |
﴿فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
﴿فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ﴾
كلتا الآيتين في المرأة التي توفي عنها زوجها.
(الباء) في الآية الأولى للالصاق، وأقرب معروف للمرأة هو الزواج.
(من) في الآية الثانية بيانية، و(معروف) في الآية نكرة عامة تعني أي معروف.
الآية الأولى ناسخة للثانية. ــــ ˮمن لطائف القرآن / صالح التركي“ ☍... |